بقلم هشام عبود
18 فبراير 2026
لم يحتج النظام الجزائري سوى إلى أيام قليلة ليناقض نفسه بنفسه. فحين سُئل الرئيس عبد المجيد تبون، في إحدى المقابلات المؤطرة بعناية من طرف صحافة مطيعة، عن احتمال زيارة لوران نونيز إلى الجزائر، أجاب ساخرًا: «نعم، فليأتِ». ردّ يحمل نبرة تهكم واستخفاف، ويعكس تشكيكًا ومسافة تجاه زيارة كانت في الواقع قيد التحضير.
ومع ذلك، تمت الزيارة.
استُقبل الوزير الفرنسي بحفاوة من نظيره سعيد سعيود لدى وصوله إلى الجزائر. وفي اليوم الموالي، استقبله رئيس الدولة شخصيًا، رغم أنه لم يكن يحمل رسالة رسمية من الرئيس الفرنسي، ولا كان موفدًا خاصًا من قصر الإليزيه. مهمة أمنية تقنية تحولت فجأة إلى محطة سياسية كبرى هدفها «إذابة الجليد» في العلاقات الثنائية المجمدة منذ صيف 2024.
في غضون ساعات، انتقل الموقف الجزائري من سخرية متعالية إلى ودّ دبلوماسي واضح.
الدبلوماسية الجزائرية: مسرح ارتجال دائم
أوضح الوزير الفرنسي أنه عمل على «إعادة تفعيل آلية تعاون أمني رفيع المستوى» وعلى «استئناف علاقات طبيعية». غير أن «الطبيعية» هي بالضبط ما تفتقده العلاقة مع الجزائر.
حتى اللحظة الأخيرة، لم تكن الزيارة مؤكدة. دعوة قائمة منذ أشهر، أُجّلت ثم عُلّقت ثم صودق عليها فجأة. هذا الأسلوب القائم على الإعلان ثم التهديد ثم التجميد ثم إعادة الفتح، أصبح سمة دبلوماسية ملازمة للنظام.
المشهد الذي بثته مصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية كان دالًا: ابتسامات واضحة، مصافحة مطوّلة، أجواء ودّية. حول الرئيس، حضر مدير الديوان، والمستشار الدبلوماسي، ورئيس الاستخبارات الداخلية. في المقابل، غاب قادة الشرطة والدرك. الاجتماع لم يعد أمنيًا فحسب، بل أصبح سياسيًا.
وهنا تكمن الثابتة: تحويل كل ملف تقني إلى ورقة استراتيجية، ثم نفي طابعه الاستراتيجي حين يصبح ملزمًا.
مفارقة الرسالة العدائية التي تحولت إلى ودّ
قبل أيام فقط، كانت الجزائر تهدد باريس على صعيد الذاكرة والقضاء.
في أديس أبابا، خلال قمة الاتحاد الإفريقي، أعلن الرئيس الجزائري في رسالة قرأها الوزير الأول عزمه إحالة «أدلة وشهادات» إلى الهيئات القضائية الإفريقية لملاحقة فرنسا بشأن الجرائم الاستعمارية، وإرساء «عدالة تاريخية».
غير أن السلطة نفسها طلبت، بعد ذلك مباشرة، من الوزير الفرنسي نقل رسالة ودّ إلى إيمانويل ماكرون.
في أقل من أسبوع، انتقلت فرنسا من «قوة يجب ملاحقتها قضائيًا» إلى «شريك أمني مميز». دون توضيح أو تفسير.
تجريم الاستعمار: أداة ضغط سياسي
يشكل «تجريم الاستعمار» أحد أكثر الشعارات استخدامًا في خطاب السلطة الجزائرية. عبد المجيد تبون يجعله موضوعًا متكررًا يُستدعى بحسب التوترات الدبلوماسية.
لكن الجميع في قمة هرم الدولة يعلم أن هذا المسار يكاد يخلو من الأثر العملي، سواء على مستوى الهيئات القضائية الدولية، أو لدى الرأي العام الجزائري المنشغل بأزمات اجتماعية واقتصادية أكثر إلحاحًا.
الأمر يتعلق بأداة ضغط أكثر منه بمشروع قانوني فعلي.
غير أن هذا التوظيف لا يحظى بإجماع. أصوات جزائرية، خاصة من شخصيات سياسية وإعلامية في المنفى، تنتقد هذه الانتقائية. حتى علي بن حاج، الرجل الثاني السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ذكّر علنًا بأن فظائع العشرية السوداء التي وقعت تحت مسؤولية أطراف من السلطة السابقة والحالية، أراقت دماء الجزائريين بوحشية يعتبرها كثيرون أشد من حقبة الاستعمار. هذا التذكير يحرج السلطة.
فهو يعيد فتح ملف الاختفاءات القسرية، والحرب الأهلية، والتصفيات خارج القانون، والتعذيب، والإفلات من العقاب. ملفات ما تزال محرّمة.
تُطالب السلطة بذاكرة كاملة للقرنين التاسع عشر والعشرين، لكنها ترفض نقاشًا عامًا حول مسؤوليات تسعينيات القرن الماضي. ذاكرة هجومية إلى الخارج، وصمت إلى الداخل.
الصحراء والذاكرة والموقوفون: اختفاء الخلافات فجأة
لأشهر، ربطت الجزائر أي تطبيع بشروط متعددة: موقف فرنسا من الصحراء الغربية، الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، التوترات القنصلية، ملفات الموقوفين، التعاون في الهجرة.
غير أن هذه الملفات اختفت فجأة من الخطاب الرسمي أثناء الزيارة. لا تذكير علني، لا إعادة طرح للشروط. خط الأمس الأحمر أصبح طيّ النسيان.
ملف إعادة المهاجرين
تسعى فرنسا إلى استئناف ترحيل رعايا جزائريين في وضع غير نظامي. الجزائر كانت ترفض منذ أشهر، مستعملة الملف كورقة ضغط.
زيارة لوران نونيز كانت تستهدف هذا الملف تحديدًا. لكن لم يصدر موقف واضح: لا اتفاق رسمي ولا رفض. فقط حديث عن «تعزيز التعاون». صيغة قابلة للتأويل والتراجع.
الأمن والمخدرات: تعاون مُعلن وغموض قائم
أشار الوزير الفرنسي إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات.
غير أن شحنات كبيرة كانت موجهة إلى الجزائر حُجزت في السنوات الأخيرة، سواء في عرض أرزيو أو سكيكدة أو في ميناء وهران سنة 2018. رغم ضخامة القضايا، لم يُعلن عن تفكيك شبكات كبرى أو كشف أسماء بارونات علنًا أو فتح تحقيقات واسعة النطاق.
الصحافة المحلية تكتفي ببيانات مقتضبة. والتعاون الأمني المعلن يصطدم بغياب الشفافية.
سياسة الإشارة المتناقضة
هذا المشهد ليس استثناءً، بل يندرج في نمط متكرر: تصعيد لفظي، ثم تجميد، ثم تقارب مفاجئ، ثم إعادة الدورة.
كل شريك أجنبي يتعامل عمليًا مع خطابين: خطاب موجه للرأي العام الداخلي، وممارسة فعلية تحكمها اعتبارات اقتصادية وأمنية.
غياب الثقة البنيوي
المشكلة ليست في حادثة دبلوماسية معزولة، بل في تكرارها. العلاقات الدولية تقوم على قابلية التوقع. وهذا العنصر غائب.
حين تتحول التهديدات إلى دعوات، والخلافات إلى صمت، والاتفاقات إلى مواقف قابلة للنقض، تفقد الكلمة الرسمية قيمتها.
زيارة لوران نونيز لم تكن فقط استئنافًا للحوار، بل مثالًا جديدًا على صعوبة بناء ثقة دائمة مع نظام تقوم استراتيجيته على الغموض والتقلب.
تطبيع مؤقت دائمًا
الرسائل الشفوية والابتسامات ووعود التعاون لا تعني استقرارًا، بل هدنة.
في منطق النظام، العلاقة الخارجية ليست إطارًا ثابتًا، بل أداة داخلية تُستعمل سياسيًا أو اجتماعيًا أو إعلاميًا.
السؤال لم يعد: هل ستتوتر العلاقة مجددًا؟ بل متى؟
في هذا السياق، كل انفراج مؤقت، وكل التزام قابل للتراجع، وكل اتفاق هش. الدبلوماسية الجزائرية ليست متوترة عرضًا، بل متذبذبة بطبيعتها.
والعلاقة المتذبذبة لا تكون موثوقة أبدًا.



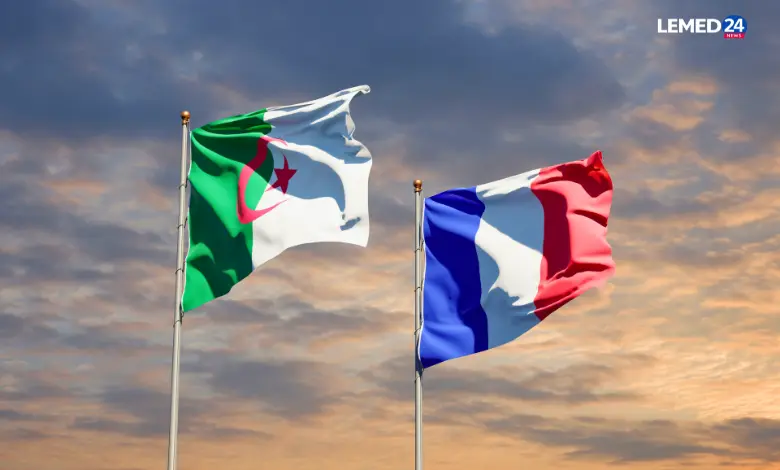
تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..